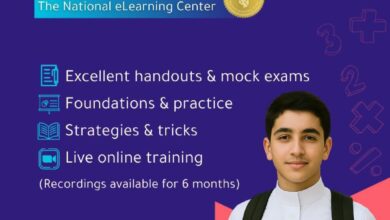هل يحتاج تراثنا الفقهي إلى اصلاح؟

مسفر بن علي القحطاني*
نادى بعض المفكرين بإصلاح تراثنا الديني أو طريقة تعاطينا مع النص على غرار ما قدمه المصلح الألماني مارتن لوثر ( 1483- 1546م)، كان من أشهرهم جمال الدين الأفغاني (1838-1896م) مع بيانه الفروق بين دوافع الإصلاح اللوثري وما كان يتطلّعه من تغيير وإصلاح (انظر: كتاب: جمال الدين الأفغاني، لعبد القادر المغربي، طبعة دار المعارف، كتاب اقرأ، رقم 68، ص:97)، ثم نادى بذلك جورج طرابيشي (1939- 2016م) في دعوته إلى إصلاح إسلامي شبيه بما قدمه مارتن لوثر بعد ثورته في التحول من مسيحية الكنيسة إلى مسيحية الإنجيل، ومن ثمَّ يرى طرابيشي أن الإسلام بحاجة إلى لوثري جديد أو ثائر مسلم، من أجل تحقيق الانتقال من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن؛ حسب زعمه.(انظر كتابه: من إسلام القرآن إلى إسلام الحديث، طبعة دار الساقي 2010م، ص 631)، هذه الدعوات التي تتجه نحو تجديد التفكير الديني وإعادة النظر في النص الديني والتراثي من خلال أنموذج مارتن لوثر أصبحت أيقونة تتكرر كثيرا على لسان دعاة التغيير، ومع نجاح لوثر في شق الكنيسة المسيحية وتعرية بعض تصرفاتها الاستغلالية واحتكارها لتفسير الكتاب المقدس؛ إلا أن هذا الأنموذج المسيحي له ظروفه التاريخية والسياسية التي جاءت لصالح لوثر أكثر من غيره، كترجمته الكتاب المقدس للألمانية بعدما كان حكرا على اللاتينية القديمة، وتحالف أمراء بعض الأقاليم معه كفريدريك الثاني لزيادة ثروتهم من أملاك الكنائس المتحولة، كما أن اهتماماته المدرسية بالشباب وألحانه الشعرية التي غنّتها الكنائس دورا كبيرا في انتشار أفكاره، ولولا يوهان غوتنبرغ (1398- 1468م) مخترع الطابعة لم عُرف لوثر، فبفضل الطابعة انتشرت مقالاته وكتبه في كافة الكنائس الألمانية وفي أوقات وجيزة، ولا يعني أن الإصلاح الديني البروتستانتي كان مثالا صالحا للتجديد والتصالح مع الإنسان والعلم في أوروبا، فقد حمل بذور الغلو والتعصب، وأشعل حرب الثلاثين عام (1618- 1648م) التي قضت على 30% من سكان ألمانيا وشردت الملايين من سكان أوروبا، كما ساهم في دمج الدين بالملك وجعلها في يد السلطة المدنية التي كانت وبالا على بعض المجتمعات الأوروبية آنذاك. ويبقى السؤال المتكرر الذي يطرحه الكثير كلما برزت قوى متطرفة أو ظهر للساحة دعاة الغلو، هل نحن في حاجة إلا مارتن لوثر مسلم يقود حركة التجديد والإصلاح الديني، والاجابة بالنسبة لي (نعم، ولكن)، وذلك لعدة أسباب، أجملها فيما يلي:
أولا: المجتمعات المسلمة في حاجة إلى مصلح ديني ولكن من غير مشابهة لأنموذج لوثر؛ فالتجديد في الدين مطلب متكرر في هذه الأمة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام:” إنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا ” (رواه أبو داود، رقمه4291 وصححه الألباني في الصحيحة، رقمه:599) فعندما يتحوّل الفرع الفقهي إلى أداة تحكم في النص، ويصبح الفقيه مشرّع في الدين بلا قيود، وتصبح الشريعة مرتعا لكل مدّعي ومنتفع، فإن التجديد حينئذ يصبح ضرورة للمؤمنين لأجل حفظ مقاصد الدين، والتحصين من الزيغ والانحراف.
ثانيا: كثرة وجود الفقهاء والدعاة والوعاظ مع مؤسسات دينية راعية وحامية لهم في أي مجتمع، يقتضي بشكل طبيعي وجود تبادل مصلحي يحدث بينهم وبين المجتمع والدولة، غالبا يكون الدين هو سوق هذه المنافع وساحة هذا النوع من التبادلات، ولهذا يمكن أن يقع المنبر الديني فريسة للسلطة السياسية، أو ينجذب المتحدثون باسم الدين إلى رغبات الجماهير أو غواية رجال المال والإعلام، فالتجديد يصبح مطلبا -مرة أخرى- للدين والمجتمع، لأنه سيعيد النظر في تلك العلاقات المتبادلة ويصحح المسارات المتعارضة التي تحدثها تلك الأنماط الاجتماعية والسياسية.
ثالثا: هناك معادلة مقلوبة في واقع الاجتماع الديني ظهرت بقوة خلال العقود الثلاثة الماضية، تتمثل في كثرة الاستفتاء وتزايد المفتين في المدن والقرى وعلى شاشات الفضائيات، وأرقام مجانية للاتصال بمفتين مجاهيل في كل وقت، كما تزامنت معها أيضا كثرة منابر الوعظ واستخدامها لكل الطرق والوسائل الحديثة الموصلة لعواطف الأفراد بشكل لحظي وتنافسي ينزع نحو المثالية والمبالغات الخرافية، هاتان الظاهرتان (كثرة المفتين والوعاظ) لم تكن هي الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصدر الأول من الإسلام؛ فالفتيا في عهده عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين كانت قليلة جدا، فعن أنس رضي الله عنه قال: “نُهِينا أن نسأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجِيء الرجل العاقِل من أهل البادية فيسأله، ونحن نسمع” (رواه مسلم رقمه: 12)، أما المواعظ فكان عليه الصلاة والسلام يتخوّلهم بالموعظة مخافة السآمة عليهم (رواه البخاري رقمه 67)، علما أن المجتمع النبوي حديث عهد بالجاهلية وبين أيديهم رسول من الله تعالى يوحى إليه، فحاجتهم للفتوى والموعظة ملحّة في شؤون دينهم ودنياهم، ولكن هل كانت تلك الحاجة مرفوضة بالكلية، أما أن الاحتياج الأهم كان يكمن في إصلاح أحوال الناس من خلال الامتثال لهدي القرآن الذي يتنزل عليهم ويسمعونه ويفهمونه بلا تعقيد، مع الاقتداء المباشر لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام الماثل بين أظهرهم. ولكي نعيد معادلة الصلاح المجتمعي للمسلمين إلى نصابها الصحيح، فعلينا العودة لقاعدتين كانتا قائمتين في الصدر الأول، وهما: العمل بالقرآن والسنة ففيهما الكفاية، والامتثال لأخلاق النبوة بالاقتداء به وبالراشدين والمهديين من بعده. وفي واقعنا الديني تم الإغراق في الفتاوى والفروع الفقهية والتعبد بالتراث على حساب النصوص الكلية العامة، كما غفل الفقهاء عن السلوك القيمي وانحسرت نماذج الاقتداء في المجتمع، ولم تعد شخصية الفقيه والداعية مثالا مطردا للنقاء والطهارة.
رابعا: يمتاز تراثنا الفقهي المعاصر بكثرة الكتب والأبحاث والدراسات التي تُنشر في المجلات والمكتبات، وفي موضوعات كثيرة ومتعددة عن الدين، ولكن عند الفحص والتدقيق لا يجد الباحث بغيته ومراده فيها، ولا يثيره الأكثر منها، وقد تمر الأعوام ولا نجد في مكتباتنا ما يستحق المراجعة والنظر، أو ما يبعث التجديد في الدين، وهذه الظاهرة الباهتة للمنتج الديني يتطلب وضع معايير جديدة وحازمة لإيقاف النشر البعيد عن الحاجة، أو الغارق في الماضي بلا نقد وتطوير، أو المتكرر مع عمل من سبقه أو عاصره، وللأسف أن سوق النسخ بلا أذن وسرقة جهود الأخرين العلمية؛ باتت مظهرا مخزيا في حقل الدراسات الإسلامية.
خامسا: إن أي عملية إصلاح في منظومة التراث الديني تتطلب عدة أمور، ولكن أهمها في وجهة نظري، أمران: أحدهما الاستقلال عن الخضوع لإملاءات السلطات الصلبة والناعمة، وليس المقصود الاستقلال المطلق فهذا شبه مستحيل، ولكن لابد أن يكون هناك قدرا من الربانية التي تجعل الفقيه والمجتهد لا يخضع إلا لله تعالى، والأمر الثاني: الحرية، التي تمنحه مناخا صحيّا للإبداع والتجديد دون خوف من جلد الخصوم أو منافرة رفقاء المذهب أو تهديد مادي يجبره على الانكفاء البحثي أو الاعتزال الاختياري. فهذان العاملان وغيرهما قد يدفعان بتراثنا للتجديد ومؤسساتنا الفقهية للعطاء والنماء المنتظر في ظل تحولات عالمية وانفتاح معرفي ونوازل فقهية تلقي بالجديد كل يوم.
وختاما.. لا نحتاج أن يهيمن على الساحة الإسلامية فريق سياسي أو حركة مؤدلجة ثم تحتكر لوحدها الحديث باسم الإسلام المعاصر، فتراثنا الفقهي قد اتسع لنشوء مذاهب ومدارس وطرق علمية وروحية في القديم وقد نحتاجها أيضا في الجديد، والمتأمل في غالب الأديان يجد أن موجات الخفوت والتطور تسير وفق خط زمني متعاقب لابد من حدوثه، وأجمل ما يتحقق به هذا النزوع نحو التجديد والتنامي حدوثه بشكل سلمي تصالحي بعيدا عن الصدام والمغالبة، فالرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع عن شيء إلا شانه.
صحيفة الحياة
أستاذ أصول الفقه بقسم الدراسات الإسلامية والعربية، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.